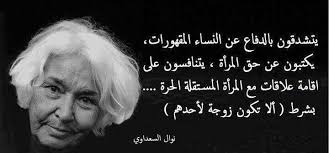“رحلتي لقلب أفريقيا جاءت متأخرة، رأيت أوروبا وأمريكا وآسيا، قبل أن أري افريقيا مع أن قارتنا هي أفريقيا، ونحن نعيش عليها، وجذورنا ومنابع نيلنا تمتد من قلبها. لكن عيوننا ووجوهنا كانت دائما تتجه نحو البحر الابيض وأوروبا وأمريكا وظهورنا ناحية أفريقيا، ناحية أنفسنا.
حينما يدير الانسان ظهره ناحية نفسه، حينما يخجل الانسان من بشرته السمراء أو السوداء ويحاول أن يخفيها بمسحوق أبيض. كيف يعرف نفسه. كم أساء الاستعمار الاوروبي للانسان الافريقي حين استنزف موارده وثرواته
لكن الاساءة الكبري كانت ذلك السهم الذي صوبه الرجل الابيض الي شخصية الانسان الافريقي، فأصبحت افريقيته وصمة عار وبشرته السوداء صك عبودية. وقد استغرقت رحلتي الاولي لشرق وغرب القارة ثلاثة شهور الصيف عام 1977 وهي مدة قصيرة لا تكفي للدخول في قلب الانسان الافريقي، لكنها كانت كافية علي الاقل لأن أدخل في قلبي
وأتعرف علي نفسي وعلي كوني أفريقية.
ان أول مظاهر أفريقيتي هو لون بشرتي السمراء، واعترف بأن ذلك لم يكن يبهجني في الماضي، ففي أعماقي منذ الطفولة حنين لأن أكون بيضاء مثل الأوروبيين. مازلت أذكر رغم مرور السنين أنني منذ ولدت ادركت حقيقتين اثنتين لاشك فيهما، أولهما انني بنت ولست ولدا مثل أخي وثانيهما أن بشرتي سمراء وليست بيضاء مثل أمي. ومع هاتين الحقيقتين ادركت شيئا آخر أكثر أهمية.
ذلك ان هاتين الصفتين وحدهما وبدون أي عيوب أخري كافيتا للحكم علي مستقبلي بالفشل. كان المؤهل الوحيد الذي يرشح البنت في ذلك الوقت لمستقبل مضمون هو أن تكون جميلة، أو علي الاقل بيضاء البشرة مثل الاتراك. وكانت جدتى لأمى ذات الأصل التركى تنادينى باسم ورور الجارية فى بلاط جدها «الباشا» بإسطنبول. لهذا منذ طفولتى أدركت أن بشرتى بلون بشرة العبيد فأصبحت أخفيها بمسحوق أبيض تشتريه خالتى نعمات (شقيقة أمي) من الصيدلية المجاورة مع سوائل لتبييض الوجه، وأخرى لتسويد العينين بالكحل، وأصبح إخفاء وجهى الحقيقى هو الخطوة الأولى نحو الجمال الصحيح لكنى وللغرابة الشديدة كنت أدرك بجزء غامض فى مركز ذاكرتى مدفون فيها منذ ما قبل التاريخ أننى جميلة بل أجمل البنات عن يقين، وبشرتى السمراء الخمرية بلون طمى النيل أجمل بشرة فى الوجود، وهى حقيقتى التى أفخر بها (فى سري) وأحبها بل إنها حبى الحقيقى الوحيد هكذا أصبحت بعد أن كبرت قليلا أمتلك الشجاعة لأواجه العالم بوجه مغسول دون مساحيق وأشعر بالراحة داخل بشرتي، والألفة مع جسمى ونفسي، ومع الأصدقاء والصديقات الإفريقيات بل وقعت فى حب رجل سنغالى فى أول رحلة لى الى داكار.
وفى نهاية السبعينيات حين أصبحت مستشارة باللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة كانت إقامتى فى أديس أبابا لكن عملى كان يقتضى سفرى لجميع البلاد الإفريقية فى رحلات قصيرة وطويلة لم تكن كافية لأدخل فى قلب القارة الشاسعة العريقة، وإن كانت كافية لأدخل فى قلبي، وأتعرف على نفسى وكونى إفريقية. كنت أجلس وسط النساء والرجال الافريقيين في دار السلام ، بشرتهم سوداء ، قامتهم طويلة ممشوقة، حركتهم في السير الطبيعي تشبه الرقص. عيونهم وهم يتحدثون تشبه الغناء، وغناؤهم للحب كغنائهم للثورة
وكلمة الحرية بلغة السواهيلي تشبه كلمتنا العربية الحرية مع اختلاف بسيط في النطق أهورو، قد أعجبني نطقهم وغنيت معهم اهورو وقالوا لي أنت افريقية مثلنا لكنهم مزقوا قارتنا، وفصلوا بين الشمال والجنوب فهذه أفريقيا السوداء
وهذا حوض البحر الابيض، أو الشرق الاوسط، كأنما شمال أفريقيا ليس من أفريقيا، وكأنما هناك افريقيا سوداء وأفريقيا بيضاء.
شعرت بالراحة معهم، والتآلف مع نفسي، ومع بشرتي السمراء. ان أجزاء نفسي الحقيقية تظهر وتملأني بالثقة والفخر
فالرحلة الي أفريقيا أشبه ما تكون برحلة الي النفس، الي أعماق النفس بقدر ماهي رحلة الي جذورنا ومنابع النيل. احساس لم أدركه في رحلاتي الي أوروبا وأمريكا أو آسيا. احساس بعد أن عرفته ندمت لأن رحلتي الي افريقيا جاءت متأخرة، لكني كنت كالاخرين أحلم بالسفر الي أوروبا أو أمريكا ولا أذكر انني حلمت مرة واحدة بالسفر الي أفريقيا
تماما مثل القناع الذي كنت أرتديه فوق وجهي علي شكل مسحوق أبيض.
لا أنسي في أول رحلة لي لأمريكا سنة 1965 انني توقفت أمام المرآة وفي مدينة رالي بنورث كارولينا قبل أن أدخل دورة المياه، فقد قرأت علي الباب لافتة كتب عليها:
خاص بذوي البشرة البيضاء وعلي الباب الآخر كانت هناك لافتة أخري كتب عليها: خاص بذوي البشرة السوداء .
ذلك اليوم وقفت أمام المرآة متحيرة، أي باب أدخل، فلم يكن لون بشرتي أبيض أو أسود وانما هو لون متوسط بين البياض والسواد ولم أعرف الي أي عالم أنا انتمي، الي عالم البيض أو عالم السود، قد ضحكت صديقتي التنزانية عندنا سمعت هذه القصة، اسمها باريز وهي استاذة اقتصادية بجامعة دار السلام ، ولها أربعة أطفال، اثنان منهما حصلا علي اسم الأب، والاثنان الآخريان حصلا علي اسم الام، فالمرأة الافريقية في بعض البلدان تعمل مثل الرجل وتنسب أطفالها اليها. وقالت لي باريز “درست في انجلترا سنة 1959 وكانوا يشعرونني بالنقص لأنني سوداء، ولأنني امرأة الي حد انني اصبحت أخجل من نفسي ولكنني تغيرت كثيرا بعد أن درست الاقتصاد، وعرفت كيف استعمرونا وخربوا اقتصادنا وخربوا نفوسنا. اني أعيش وأري الاشتراكية تتحقق تدريجيا في بلدي تنزانيا وأدرك بمرور السنين الارتباط الوثيق بين العدالة الاقتصادية وبين حرية الرجال والنساء، في تراثنا الافريقي الاصيل نحن لا نفرق بين الرجل والمرأة، هل تعرفين أن وزيرة العدل عندنا امرأة اسمها مانينج هل هناك وزيرة العدل في أي بلد من تلك البلاد التي تسمي نفسها بالبلاد المتقدمة.”
واعطتني رقم تليفون وزيرة العدل في بيتها ومكتبها، وقلت الافضل أن أكلمها في المكتب لا البيت، فقالت بدهشة ما الفرق؟ وأدركت أن الناس في أفريقيا يتعاملون مع الوزراء والحكام كما يتعاملون مع الناس العاديين فلا أبواب ولا حجب ولا تشنجات. وتحدثت مع وزيرة العدل في بيتها وسألتها هل أنت وزيرة العدل حقا؟ وضحكت مس مانينج وهي تقول عندنا النساء في كل مجال وعندنا وزيرات غيري. قلت لها نحن عندنا وزيرة واحدة للشئون الاجتماعية أما العدل فهذا لازال في بلدنا حكرا علي الرجل وحده.، تذكرت وأنا أحادث وزيرة العدل الافريقية مقالا كنت قرأته في احدي الصحف المصرية العام الماضي يقول فيه كاتبه أن هناك شروطاً يجب أن تتوافر في الشخص الذي يتولي منصب القاضي وأول هذه الشروط هي الذكورة .
كنت أتلفت حولي وأنا أتجول علي شاطيء المحيط الهندي علي ساحل شرق أفريقيا في كينيا وتنزانيا وزنزبار
وجزر القمر ومدغشقر وأندهش لهذا السحر الذي لم أره من قبل. جبال كينيا وقمة كليمانجارو الشاهقة في تنزانيا
لاتقل روعة عن جبال الهيمالايا التي رأيتها في نيبال. وجبال إثيوبيا الكثيفة الخضراء، وأوغندا تشبه الجنة الخضراء
حول بحيرة فيكتوريا. هذا الجمال الذي رأيته في شرق أفريقيا لم أره في سويسرا، كثيرا ما سمعتهم يشيدون بجمالهاويتفاخرون بالسفر للمصيف في ربوع شواطئ أوروبا، مع أن شواطيء وجبال شرق أفريقيا أكثر جمالا وخضرة
امتزاج الجبل بالماء بالخضرة الاستوائية الداكنة، وأشجار المانجو وجزر الهند، ورائحة الزهور الاستوائية القوية
وتلك البرودة المنعشة في الجو، أكثر انعاشا من برودة صيف أوروبا.
كنت أظن أنني سأسطلي نارا في أغسطس وأنا أتجول في أفريقيا تحت خط الاستواء، لكني وجدت أن الارتفاع عن سطح البحر آلاف الأقدام يحمي معظم هذه البلاد من الحرارة
ويصبح الجو معتدلا أشبه ما يكون نحو الربيع في بلادنا مع بعض البرودة الخفيفة أحيانا اذا اشتد الارتفاعوكما هو الحال في أديس أبابا أو نيروبي.
السخونة في شرق أفريقيا في الجو السياسي، وهي سخونة طبيعية، فالاستعباد الطويل يؤدي في النهاية الي ثورة ساخنة، لها ايجابياتها ولها أيضا مخاطرها، حين قلت في القاهرة انني ذاهبة الي أفريقيا أتسمت العيون دهشة وحذرني الجميع، فالثورة كانت مندلعة في كل مكان، لكني صممت علي الذهاب، فأنا أحب أن أكون حيث يكون الانسان ثائرا وغاضبا. ان الغضب في رأيي هو الحالة النفسية المتلائمة مع هذا العصر، لا شيء يؤلمني أكثر من ابتسامة انسان مستعبد أو استكانة شعب مستعمر أو محكوم بأقلية جشعة. كما أنني منذ المدرسة الابتدائية وأنا اسمع عن بحيرة فكتوريا ومنابع النيل، وعندي رغبة ملحة في البحث عن منابعي وجذوري، كان جدي لأبي اسمه حبشي وبعضهم قال لي أنه كان أسمر وفيه دماء إثيوبية. وكانت أمي حين تغضب مني تقول انني ورثت بشرة أهل أبي – أليس من حقي بعد كل ذلك أن أعرف جذوري ومنابعي، أما منابع النيل فقد وقفت في أوغنده مشدوهة أمام روعة الضفاف العالية الخضراء في جنجا بالقرب من كمبالا نقطة الالتحام بين النيل الابيض وبحيرة فيكتوريا، وحيث انشيء حديثا شلال أول الذي يعترض المياه المتدفقة بغزارة نحو النيل. وقفت أتأمل عنق النهر الضيق عند نقطة الالتحام مع منبعه، وارتفعت يدي دون وعي أتحسس عنقي، أحساس له رهبة غريبة ورجفة، ذلك أن هذا العنق الصغير الضيق هو شريان الدم في أرض جسدي.
إنه عنقي ومع ذلك فهو ليس في جسدي، وانما هو في جسد آخر، أوغندا، تموج بأعنف الهزات السياسية في عهد عيدي أمين.
وعلي هضبة اثيوبيا العالية وفي أديس أبابا التي ترتفع عن سطح البحر بحوالي سبعة آلاف قدم كانت الامطار تهطل طول النهار والليل وأدرك بحكم معلومات الابتدائية ان هذه الامطار تحمل الري والطمي الينا فاغتبط لصوت الرعد وأقول لنفسي: “هذه المياه الغزيرة ستتدفق علي أرض أهلي الفلاحين، وسمرة أهل اثيوبيا كسمرة أقاربي في قريتي كفر طحلة وفيهم أيضا تلك الوداعة والهدوء رغم التقاطيع الحادة التي تنقلب بسرعة عند الغضب كما ينقلب الجو فجأة
من شمس ساطعة الي برق ورعد ومطر. وفي أوغنده أيضا تري الملامح فيها رقة وهدوء لكنها سرعان ما تتغير عند الغضب وتصبح حادة كالسيف أو كطلقة الرصاص.
علي مصر ان تعود الى حضن الأم “إفريقيا” بعد انتزعت منها قسرا لتكون منطقة ضبابية معلقة بين القارات أطلق عليها المستعمرون اسم الشرق الأوسط.”
 Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر
Laa-Laa لا لا موقع شباب السودان الحر